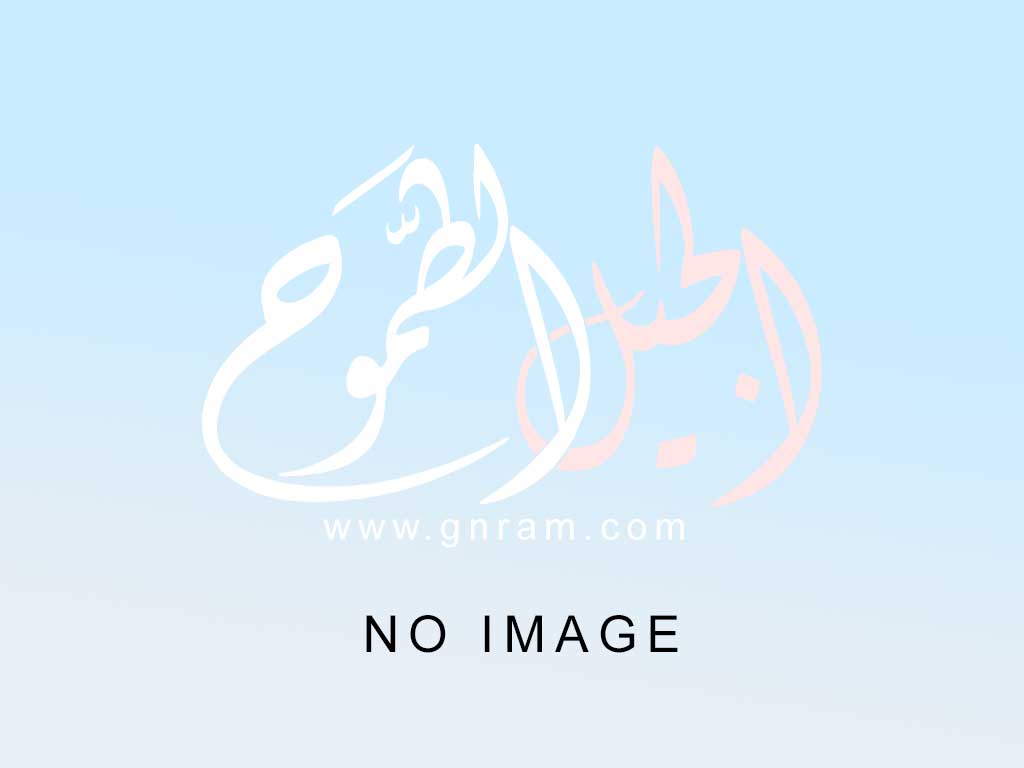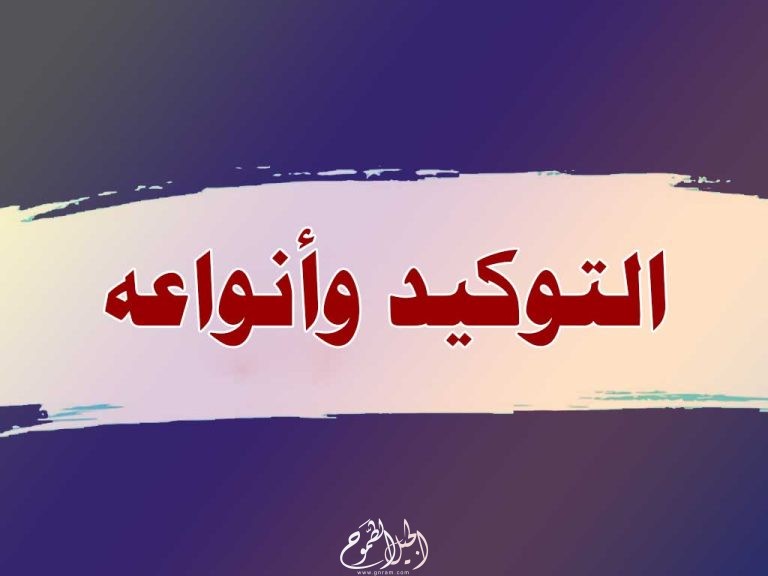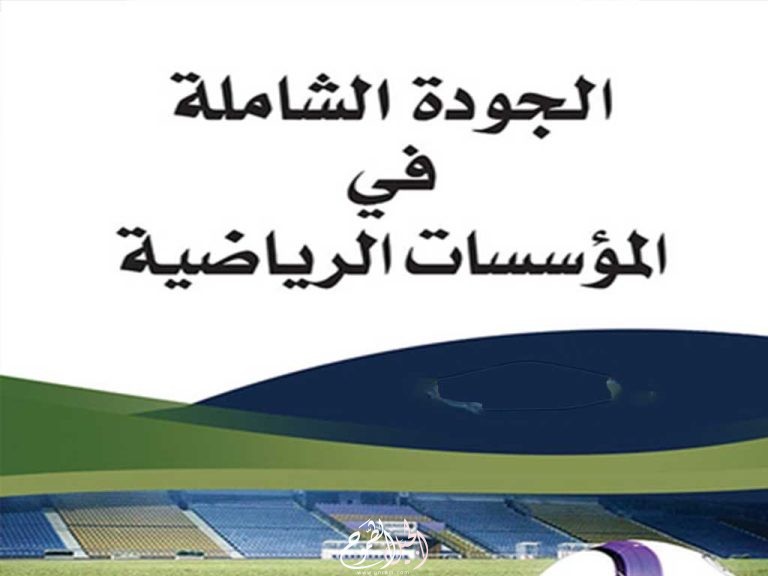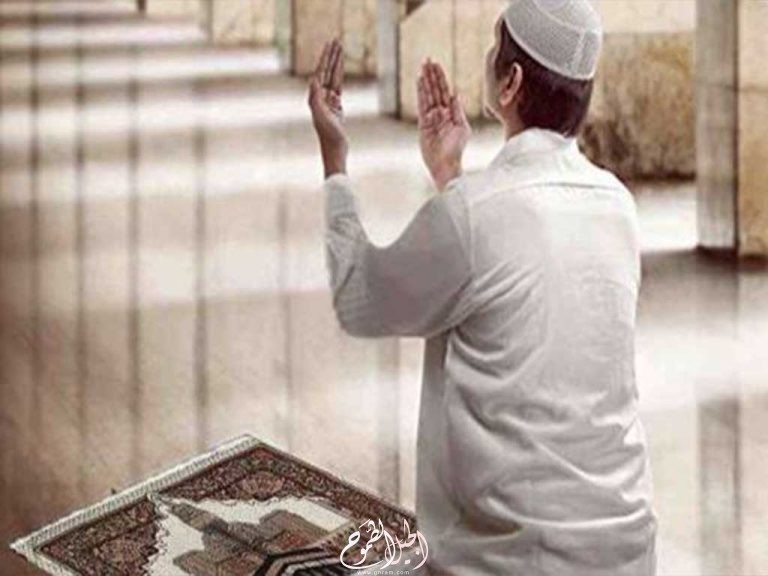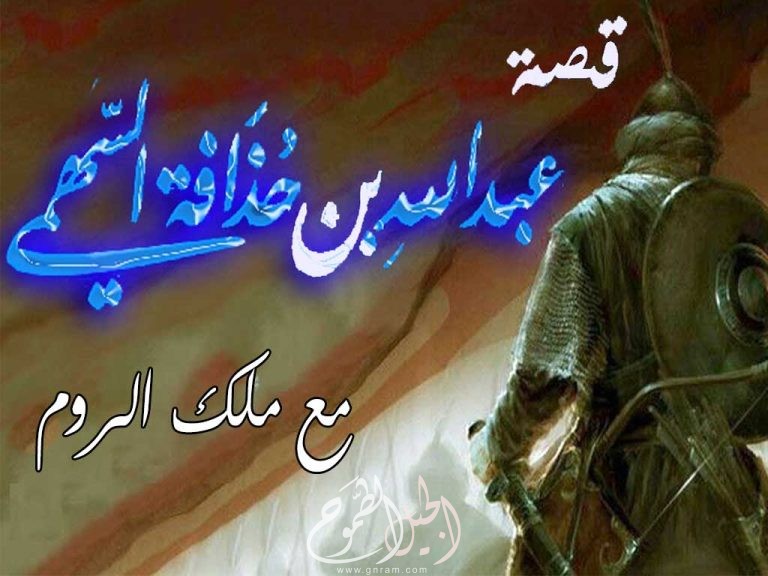التورية في اللغة العربية
مفهوم التورية
بابُ التورية جزء لا يتجزّأ من علم البديع الذي ينقسم إلى محسنات لفظية ومحسّنات معنويّة، وهو جزء من علم البلاغة العربية، الذي يتكوّن من ثلاثة أقسام، وهي: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، والتورية في معناها المعجميّ هي إخفاء الشيء
أمّا معناها الاصطلاحيّ المُراد في علم البديع هي ذِكر لفظ معيَّن، ولهذا اللفظِ معنيان؛ أحدهما مُتبادر للذهنِ يَسهلُ على المُخاطَب فهمه من سياق الجملة، والمعنى الآخر بعيد عن ذهن المخاطب، ويكون الأوَّل(الظّاهر القريب) غير مُراد في قصد المتكلّم، بينما يكون المعنى الآخر(الخفيّ البعيد) هو المعنى المقصود
قد تتشابه التورية في علم البديع مع الكناية في علم البيان، لكن الفرق بينهما أنّ التورية لفظها يحتمل معنيين لكلّ منهما مفهوم دون علاقة بين المعنيين، ولكن المتكلم قصد واحدًا دون الآخر، أمّا في الكناية فهناك علاقة تَلازُم تربط بين المعنيين اللذين يُشير إليهما اللفظ
ثمَّ إنَّ التورية في أساليب العرب تفيدُ بإخفاء ما يريد المتكلم دون أن يُشعِر المُخاطب بأنّه يُخفي مراده، فتحصل بها فائدة تتأتّى في مواقف قد يصعب الخلاص منها دون ذلك، ولا يُمكن الاكتفاء بالرجوع إلى الأصل المعجمي لفهم مغزاها، أمّا الكناية فغرضها استخدام الأسلوب غير المباشر مع المخاطب، ليكون أكثر وقعًا في نفسه
يُمكن القول: إنّ التورية قد تُسمَّى تخييلًا، أو إيهامًا، أو توجيهًا، لأنَّ كلّ تلك المعاني تُعبّر عن أنها لفظ يُراد به معنيان، أحدهما قريب غير مقصود، والآخر بعيد وهو المقصود.
أنواع التورية
لا بدّ من التّمييز بين المورّى به وهو المعنى القريب غير المُراد، والمُورّى عنه وهو المعنى البعيد المراد، وتتعدّد أنواع التورية بحسب سياق الجملة والمعنى الذي يَرد فيه لفظها، أمّا أنواع التورية فقد جُمعت في أربعة أشكال:
- التورية المجردة
هي التورية التي لا يُذكَر فيها ما يدلُّ على المُورَّى به، أو يدلّ على المورَّى عنه، فلا يُمكن الاستدلال على خفايا التوريةِ بشيء ممّا يلائم أحد أركانها، فهذا النوع من التورية يعتمد على فهم المخاطب للمعنى الذي أراده المتكلّم، دون وجود ما يدلّ على ذلك المعنى.
- التورية المبينة
في هذا النوع تشتمل الجملة على لفظ أو معنى يدلّ على المورى عنه، فيمكن للمخاطب أن يتبيّنه ويهتدي إليهِ، إذ المتكلم لم يترك المعنى مجرَّدًا من الإيضاح، ولذلك سُمّي هذا النوع من التورية بهذا الاسم، حيث يحتوي على شيء من التبيان لما يريد المتكلم إخفاءه.
- التورية المرشحة
أما هذا النوع فهو أشدّ الأنواع إيغالًا في الإيهام، فهنا يذكر المتكلم ما يدلّ على المورى به، أي على المعنى القريب غير المراد، وبذلك يقترب هذا المعنى من ذهن المخاطب، ويبتعد عن ذهنه المعنى المورى عنه فيزداد تخفِّيًا واحتجابًا، وقد تأتي الألفاظ الدالة على المورى به قبل لفظ التورية أو بعده.
- التورية المهيأة
هذا النوع يحتوي على دلائل، ولكنّ هذه الدلائل هُنا تدلّ على التوريةِ بأكملها، لا على رُكن واحد من أركانها دون غيرهِ، وهي إمَّا مُهيَّأة بلفظ قبلها، لولاه لما تهيَّأت التورية في الجملة ولا فُهِمتْ، أو مهيَّأة بلفظ بعدها، لولاه أيضًا ما فُهمتْ التورية في الجملة، وإمّا مُهيّأة بلفظين، لولا كلّ منهما لما تهيَّأت التورية في الآخر.[٦]
إنّ أنواع التوريةِ جميعها تَتبع للمورّى به والمورّى عنه، وحسب وجود أيّ منهما في السياق وعدمه يكون إطلاق التسمية على التورية، فإما مجرّدة من أي دليل، أو دالَّة على معنى عام، أو مفضِّلة لمعنى دون الآخر.
أمثلة عن التورية
وردتْ التورية في شعر العرب، وفي القرآنِ الكريم، كما وردت في الحديث النبويّ
التورية في القرآن
إنّ الأمثلة الواردة في القرآنِ الكريم تُبيّن أهميّة التورية في أداء المعنى المُراد على أتمّ وجه، ومن ذلك ما يأتي:
- يقولُ الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ}
، فكلمة (جرحتم) في هذه الآية يحتملُ تفسيرها معنيان، المعنى الأول هو الجرح الذي يُصيب الجلد، وهو المعنى القريب المُتبادر للذهن، ولكنه غير مُراد، أما المعنى الثاني المقصود هو ارتكاب الذنوب والمعاصي ، وهو المعنى الذي تحمله أيضًا الكلمة ذاتها
، فمعنى الآية أنّ الله تعالى هو الذي يتوفّى أرواحكم في الليل فيقبضُها من أجسادكم، ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. فالاجتراحُ عند العرب هو عمل جوارح البدن، واستُخدم للذنب لأنّ الاجتراحَ غالبًا ما يكون في السرّ لا في العلانية.
- يقولُ الله تباركَ وتعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون}
، فكلمة (يد) في هذه الآية بمعناها القريب الظاهر هي العضو المعروف من جسم الإنسان، وهذا المعنى غير مُراد، أما المعنى المُراد منها هو الصَّغار والذُّل، وهو المعنى الخفيّ الذي يؤدّي دورَهُ في الآية[٩]، ويؤكّدُهُ ما بعد ذلك من قول الله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُون}، أي أذِلَّاء، فقد نزلت هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب، بعدما دخل الناسُ في الدينِ الإسلاميّ أفواجًا، في السنة التاسعةِ للهجرة، فتجهَّز النبيّ صلّى الله عليه وسلم لقتالِ الرّوم، فكانت غزوة تبوك.
التورية في الحديث النبوي
- “عن أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنهُ قال: أقبلَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُردِفٌ أبا بكرٍ، وأبو بكرٍ شيخٌ يُعرَف، ونبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شابٌّ لا يُعرَف، قال: فيَلقى الرَّجُلُ أبا بكرٍ فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجُلُ الذي بين يَديك؟ فيقولُ: هذا الرَّجلُ يهديني السَّبيل. فيَحسَبُ الحاسبُ أنهُ إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيلَ الخير”
فالمعنى الظاهرِ يدلُّ على هداية الطريق التي يمشي فيها الناس، أما المعنى الخفيُّ هو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريقِ الرحمة، فاستطاع بهذه التورية تخليص النبيّ من قتل المشركين وإيذائهم له، فأدَّتْ التورية هنا دورًا جليلًا.
- “عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلّم- أنهُ لقيَ طليعةً للمشركينَ وهو في سفَرٍ مع أصحابِهِ، فقالَ المُشركونَ: ممن أنتم؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: نحنُ من ماء، فنظرَ بعضُهم إلى بعضٍ وقالوا: أحياءُ اليَمنِ كثيرة، لعلَّهم منهم، وانصرفوا”
وفي كلامه -صلى الله عليه وسلم- إيهامٌ للمشركين بأنهم من قبيلة يمنيّة اسمها ماء، أما المعنى الخفيّ فهو الماء الذي يُخلق منه الإنسان، وقد استطاع في هذا الموضع ببلاغتهِ وحكمته أن ينجو من بطش المشركين.
التورية في الشعر
1
أصونُ أديمَ وجهي عن أناسٍ لقاءُ الموتِ عندهمُ الأديبُ
وربُّ الشِّعر عندهمُ بغيضٌ ولو وافى لهم بهِ حبيبُ
في هذا البيت يصف الشاعر جماعة من الناس يكرهون الشعراء، وكل ما يأتي من الشعراء، فلقاء الشاعر عندهم كلقاءِ الموت، وإن أتاهم بالشعر إنسان محبّب إلى قلوبهم. هذا هو المعنى الظاهر المُتبادر للذهن، ولكنّ الشاعر في كلمة حبيب لم يكن يريد هذا المعنى المباشر من كلمة (حبيب)، وإنما أراد المعنى الخفيّ لها، وهو الشاعر أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي)، فرغم بلاغة أبي تمام وعلوّ شأنه في الشعر وشهرته الواسعة لا يقبل هؤلاء الناس الشعر منه لشدِّة رفضهم للشعر وأربابه
2
يا عاذِلي فيهِ قُل لي إذا بدا كيفَ أسلو
يمرُ بي كلَّ وقتٍ وكلّما مرَّ يحلو
قد يبدو لقارئ هذه الأبيات أنّ الشاعر يقصد معنيين لكلمة يمرّ، المعنى الأوَّل من المرارة، والمعنى الثاني من المرور، ولكنّ المعنى القريب الظاهر هو المرارة؛ لأنَّه أتبعه بكلمة تدلّ على التذوق وهي كلمة يحلو، فهو معنى غير مُراد، والمعنى الخفيّ الذي يقصده الشاعر هو أنّ هذا المحبوب كلّما مرّ من أمامه يزداد حلاوة وجمالًا، فكانت التورية في اللّفظين (يمرَّ، يحلو)، ويُمكن لكلّ منهما أن يُفسّر حسب ما يَعنيه اللفظ الآخر، وهذا من أصالة اللغة العربية واتّساع إمكاناتها اللغويّة والأسلوبية